أحمد
عضو نشيط

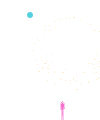
عدد المساهمات : 2407
السٌّمعَة : -667
تاريخ التسجيل : 08/01/2010
العمر : 46
 | |  (( العرب )) وجهة نظر يابانية ،،، (( العرب )) وجهة نظر يابانية ،،، | |
أخواني الأحبة أعضاء هذا المنتدى الطيب : نظراً لأهمية هذا الكتاب فإنني أنقل لكم هذا الموجز عنه ،،، خصوصاً وأن الكاتب ليس من دولة استعمارية لها مطامع في منطقتنا على الأقل ،، وليس له تاريخ عنصري معنا وهو كاتب صريح ،،، ومحب لنا يقدم نصحه ومحبته الخالصة ، وتجربته الشخصية مع الاستعما والقوى الإمبريالية قريبة من تجربتنا العربية ،،، فهو يكتب بتجرد ودون تحيز أو بناء على صورة نمطية سابقة ،،،
أتمنى من الجميع القراءة والتمعن والمتابعة لعموم الفائدة وشكراً ،،،،

الكتاب: العرب .. وجهة نظر يابانية
المؤلف: نوبوأكي نوتوهارا
الناشر: منشورات الجمل/ المانيا/ الطبعة الاولى/2003
شبكة النبأ: يقول المؤلف في مقدمة الكتاب، أربعون عاماً من عمري هي مدخلي إلى هذا الكتاب: بدأتها طالباً في قسم الدراسات العربية بجامعة طوكيو للدراسات الأجنبية ثم مدرساً للأدب العربي المعاصر في الجامعة نفسها.
أربعون عاماً وأنا أسافر إلى العواصم العربية والأرياف والبوادي. أرى وأتامل وأكتب انطباعاتي للقارئ الياباني. اربعون عاماً وأنا أتابع الرواية العربية فأتعلم وأترجم وأتحدث للناس هنا في اليابان.
قابلت كُتّاباً عرباً في البلدان العربية كلها: ولي أصدقاء كثيرون أحبهم وأحترمهم وأعتز بصداقتهم وأقمت مع الفلاحين في ريف مصر، ومع البدو في بادية الشام، وهناك تعلمت عميقاً دروساً في الحياة والثقافة وحوار الشعوب. أربعون عاماً تدفعني دفعاً لأقول بعض الأفكار والانطباعات عن الشخصية العربية المعاصرة.
تجربتي تقودني إلى هذا الكتاب وعلاقتي الحميمة مع الشخصية العربية تشجعني، وأعترف أيضاً أن بعض أصدقائي العرب ألحوا عليّ أن أكتب بالعربية شيئاً مما أعرفه – على تواضعه – وها أنذا افتح عيني على مداهما لأرى بعين المراقب المقارن، ولكن المقارن المحب الحريص، المراقب الذي أعطى الشخصية العربية حتى الآن اربعين عاماً من عمره.
غياب العدالة الاجتماعية!
أول ما اكتشفت من البداية في المجتمع العربي هو غياب العدالة الاجتماعية، وهذا يعني غياب المبدأ الأساسي الذي يعتمد عليه الناس، مما يؤدي إلى الفوضى. ففي غياب العدالة الاجتماعية وسيادة القوانين على الجميع بالتساوي يستطيع الناس أن يفعلوا كل شيء. ولذلك يكرر المواطنون دائماً: كل شيء ممكن هنا. وأضيف كل شيء ممكن لأن القانون لا يحمي الناس من الظلم.
تحت ظروف غياب العدالة الاجتماعية تتعرض حقوق الإنسان للخطر. ولذلك يصبح الفرد هشاً ومؤقتاً وساكناً بلا فعالية لأنه يعامل دائماً بلا تقدير لقيمته كإنسان. واستغرب باستمرار لماذا يستعملون كلمة الديموقراطية كثيراً في المجتمع العربي؟
إن ظروف الواقع العربي لا تسمح باستعمالها لأن ما يجري فعلاً هو عكسها تماماً.
عندما تغيب الديمقراطية ينتشر القمع، والقمع واقع لا يحتاج إلى برهان في البلدان العربية. فعلى سبيل المثال الحاكم العربي يحكم مدى الحياة في الدولة الدينية أو الملكية أو الجمهورية أو الإمارة أو السلطنة. ولذلك لا ينتظر الناس أي شيء لصالحهم.
وكمثال آخر فإن معظم الصحف العربية تمنع من بلد إلى بلد والرقابة على الكتب والمجلات ليست بأقل من الرقابة على الصحافة. هنا مئات الكتب العربية، وغير عربية ممنوعة في معظم البلدان العربية وخاصة الكتب التي تعالج الحقائق اليومية الملموسة للناس، والكتب التي تتعرض للدين أو الجنس أو حياة الفئات الحاكمة، أو تتكلم على واقع السجون والحريات العامة وما شابهها. ونحن نقرأ كل سنة في معارض الكتب العربية قوائم طويلة بالكتب الممنوعة دون أن يستثنى من ذلك بلد عربي واحد.
أعتقد أن القمع هو داء عضال في المجتمع العربي ولذلك فإن أي كاتب أو باحث يتحدث عن المجتمع العربي دون وعي هذه الحقيقة البسيطة الواضحة فإنني لا اعتبر حديثه مفيداً وجدياً. إذ لا بد من الانطلاق بداية من الإقرار بأن القمع – بكافة أشكاله – مترسخ في المجتمعات العربية. هل هناك فرد مستقل بفردية في المجتمع العربي؟ المجتمع العربي مشغول بفكرة النمط الواحد على غرار الحاكم الواحد، والقيمة الواحدة والدين الواحد وهكذا... ولذلك يحاول الناس أن يوحدوا أشكال ملابسهم وبيوتهم وآرائهم. وتحت هذه الظروف تذوب استقلالية الفرد، وخصوصيته واختلافه عن الآخرين. أعني يغيب مفهوم المواطن الفرد لتحل مكانه فكرة الجماعة المتشابهة المطيعة للنظام السائد.
في هذه المجتمعات يحاول الفرد أن يميز نفسه بالنسب كالكنية أو العشيرة أو بالثروة أو بالمنصب أو بالشهادة العالية في مجتمع تغيب عنه العدالة ويسود القمع وتذوب استقلالية الفرد وقيمته كإنسان يغيب أيضاً الوعي بالمسؤولية. ولذلك لا يشعر المواطن العربي بمسؤوليته عن الممتلكات العامة مثل الحدائق العامة والشوارع ومناهل المياه ووسائل النقل الحكومية والغابات باختصار المرافق العامة كلها.
ولذلك يدمرها الناس اعتقاداً منهم أنهم يدمرون ممتلكات الحكومة لا ممتلكاتهم هم. وهكذا يغيب الشعور بالمسؤولية تجاه أفراد المجتمع الآخرين. فعلى سبيل المثال، السجناء السياسيون في البلدان العربية ضحوا من أجل الشعب ولكن الشعب نفسه يضحي بأولئك الأفراد الشجعان، فلم نسمع عن مظاهرة أو إضراب أو احتجاج عام في أي بلد عربي من أجل قضية السجناء السياسيين، إن الناس في الوطن العربي يتصرفون مع قضية السجين السياسي على أنها قضية فردية وعلى أسرة السجين وحدها أن تواجه أعباءها! إن ذلك من أخطر مظاهر عدم الشعور بالمسؤولية.
إنني أفهم معنى أن تضحي السلطة بأفراد متميزين ومفكرين وأدباء وسياسيين وعلماء وفنانين وسواهم، ولكن لماذا يضحي الشعب نفسه بأولئك الأفراد؟ بالطبع أنا لا أنكر أن هناك أفراداً يلاقون تقديراً عالياً ولكن المبدأ نفسه ما زال ضعيفاً ولا يشكل قوة اجتماعية فاعلة أو مثمرة.
أخطر نتائج ذلك كله سيطرة الشعور باللا جدوى حتى لدى الطليعة المثقفة. أذكر أثناء حرب الخليج، إنني قابلت العديد من المهاجرين العرب في باريس، بعضهم مهاجر هرباً وبعضهم أقام بعد أن أنهى تحصيله العالي! وبعضهم يبحث عن شروط حياة أفضل.
ولقد قدّرت أن العراقيين خاصة ينظمون عملاً ما ولكن معظم الذين تحدثت إليهم قالوا أنهم يعيشون فقط! والسبب كما قالوا – أنهم قد خابت آمالهم إلى درجة الشعور باللا جدوى وأحياناً اليأس الكامل. أنهم لا يؤمنون بفائدة أي عمل سياسي في البلدان العربية!
واجه اليابانيون تجربة صعبة ومريرة. فلقد سيطر العسكريون على الإمبراطور والسلطة والشعب. وقادوا البلاد إلى حروب مجنونة ضد الدول المجاورة وانتهى الأمر بتدمير اليابان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية الحرب العالمية الثانية.
هذا حدث في تاريخنا القريب ودفع الشعب الياباني ثمناً باهظاً. ولكننا وعينا خطأنا وقررنا أن نصححه فأبعدنا العسكريين عن السلطة وبدأنا نبني ما دمره القمع العسكري. لقد عانى اليابانيون كثيراً لكي يخرجوا من الخطأ واستغرق ذلك أكثر من عشرين سنة.
ومن المعاناة نفسها تعلمنا دروساً أظن أن المواطن الياباني لن ينساها، تعلمنا أن القمع يؤدي إلى تدمير الثروة الوطنية وقتل الأبرياء ويؤدي إلى انحراف السلطة عن الطريق الصحيح والدخول في الممارسات الخاطئة باستمرار. لقد ضحى اليابانيون جميعاً بأشياء كثيرة تحت سلطة القمع العسكرية، ولكن كان هناك فئة تربح دائماً ولا تخسر شيئاً هي فئة التابعين للسلطة العسكرية، أعني حاشية السلطة وأعوانها ومخبريها.
المهم أننا وعينا خطأنا أولاً، ثم عملنا على تصحيح الخطأ وهذا كله احتاج إلى سنوات طويلة وتضحيات كبيرة. كان علينا أن نعي قيمة النقد الذاتي قبل كل شيء ودون إنجاز النقد الذاتي بقوة لا نستطيع أن نجد الطريق لتصحيح الأخطاء.
وأضيف هنا أن الإنسان بحاجة إلى النقد من الخارج ومن الداخل أيضاً مهما كان موقفه أو وظيفته أو صفته الاجتماعية وبرأيي أن الشخصية أو الحزب السياسي أو الهيئة الاجتماعية التي لا تقبل النقد تنحط وتتدنى يوماً بعد يوم حتى تصل إلى الحضيض.
كثيراً ما واجهت هذا السؤال في البلدان العربية، لقد ضربتكم الولايات المتحدة الأمريكية بالقنابل الذرية فلماذا تتعاملون معها؟ العرب عموماً ينتظرون من اليابانيين عداء عميقاً للولايات المتحدة الأمريكية لأنها دمرت المدن اليابانية كافة.
ولكن طرح المسألة على هذا النحو لا يؤدي إلى شيء. علينا نحن اليابانيين أن نعي أخطاءنا في الحرب العالمية الثانية أولاً ثم أن نصحح هذه الأخطاء لأننا استعمرنا شعوباً آسيوية كثيرة ثانياً. وأخيراً علينا أن نتخلص من الأسباب التي أدت إلى القمع في اليابان وخارجها. إذن المشكلة ليست في أن نكره أمريكا أم لا.
المشكلة في أن نعرف دورنا بصورة صحيحة ثم أن نمارس نقداً ذاتياً بلا مجاملة لأنفسنا بعدئذ نختار الطريق الذي يصحح الانحراف ويمنع تكراره في المستقبل. أما المشاعر وحدها فإنها مسألة شخصية محدودة لا تصنع مستقبلاً. من هذا الموقع نفهم مأساة هيروشيما وناغاساكي. ونفهم علاقتنا مع العالم. نحن اليابانيين نفهم إلقاء القنبلة الذرية على مدننا مقترنا بأخطائنا التي ارتكبناها في الحرب العالمية الثانية وقبلها. رغم إننا نحمل في مشاعرنا وتفكيرنا الكراهية الأشد للقنابل النووية واليابانيون أكثر شعب في العالم ينتقد السلاح النووي ويكرهه ويدعو إلى التخلص منه. لقد دفعنا الثمن وبقيت لنا مشاعر الحزن والمرارة ولكننا نجحنا إلى حد مقبول في تصحيح أخطائنا في هذا المجال.
ثقافة الأنا وثقافة الآخر
مشاكل بلدان العالم الثالث كثيرة وخطيرة. والفقر موجود بقوة في قاع المجتمع، ولكن من الضروري أن نفهم أن الفقر في أي منطقة من العالم له ميزات خاصة بتلك المنطقة وبالتالي تكون معالجته مرتبطة بخصوصية معانيه وارتباطاته.
المعيار الذي يعبر عن الفقر مختلف من بلد إلى بلد ومقياسه مختلف، ومعالجته مختلفة أيضاً وعلى سبيل المثال، في مجتمع البدو الطبيعة هي التي تسبب الفقر لأنها تخطف المواشي بسبب الجفاف، وفقدان الماء والأعشاب، وهذا السبب مختلف من حيث المبدأ عن السبب في المجتمعات الصناعية ومجتمع المدينة ولكن رغم الفقر في الصحراء فإن البدو يحافظون على استمرار أخلاق الضيافة والصدقة دون أن تتأثر أو تتدنى تحت ضغط موضوعة الفقر. نحن نعرف أن العالم الثالث يشهد حالات من الفقر تتجاوز حدود المعقول.
إن الأمر يصل إلى حد تهديد حياة الناس بصورة خطيرة. يذكر صاحب كتاب (الطوارق تحت الجفاف والجوع) يذكر أن النساء يجمعن روث الماعز، وينقين الحبوب التي لم تهضم.
حاولت أن أوضح كيف يجب علينا أن ننظر إلى ثقافات بلدان العالم الثالث، وقد علقت على بعض نقاط الموضوع من خلال بعض الأمثلة التي تتقاطع في نقطة واحدة سأسميها بعد قليل.
لماذا يشعر الإنسان بالحرج عندما يستجدي شيئاً من الآخرين على الرغم من أنه يكون في أمس الحاجة؟ ولماذا يطلب عندما تصل الحاجة إلى المستوى الحاد؟ لماذا لا يمكن أن نحل مشكلة الجوع على أنها مسألة الجوع فقط؟ أي لماذا يرتبط الجوع بقيم أخرى؟ كيف يجب أن نساعد الآخر أو نفكر في حل مشكلته؟ هذه الأسئلة وما هو من نوعها تلتقي في نقطة هي قرب شرف الإنسان، أو في ما يسمى في اللغة العربية، الكرامة. ومفهوم الكرامة في القاموس العربي ينطوي على؛ السمو، النبل، الكرم، الشرف، الاحترام، التقدير، الجلال، المشاعر النبيلة، المبادئ الرفيعة.
الكرامة أو الشعور بالشرف هو الذي يصعد من الداخل عندما يضطر الفرد في حالة خاصة لأن يطلب من الآخرين. ولكن علينا أن نفهم الكرامة في حركتها وتطورها إذ لا يكفي الوصف ولا يكفي أن نرد المشكلة إلى الشعور بالشرف. علينا ألا نسدل الستارة أبداً، لا بد من مراقبة ظهور حالات جديدة بمتابعة كافة أشكال تعبيرات الكرامة على مستوى الفرد وعلى مستوى الشعب وأعتقد أن علينا أن نوسع مفهوم كرامة الإنسان، من خلال دراسة أعماله وسلوكه ومسيرته كلها.
إن المهم في النهاية هو أن علينا أن نقبل قيم المجتمعات الأخرى كما هي دون أن نشوهها أو نخفض من قيمتها على ضوء قيمنا نحن. وعلينا إذن أن نرى المجتمعات الأخرى كما هي، وأن نقبلها كما هي عليه.
كارثة القمع وبلوى عدم الشعور بالمسؤولية
نحن في اليابان عرفنا تجربة طويلة مع القمع وعانينا من كافة أشكاله في تاريخنا. وحتى بعد الحرب العالمية استمرت مظاهر القمع في الحياة الاجتماعية اليابانية. بعد ذلك التاريخ المرير الطويل خرجنا من القمع نحن لم نتخلص تماماً من ممارسات تصادر حريات الأفراد ولكننا تعلمنا من تجاربنا وعرفنا كيف نتصرف بمسؤولية تجاه الوطن وتجاه الآخرين.
لقد اجتزنا مسافة طويلة على طريق الحياة وما زلنا نعمل بدأب لكي نتحرر من رواسب القمع التي ورثناها عن ماضينا ولكي نتحرر من الأشكال القمعية الجديدة التي ترافق التطور الصناعي الكبير.
أظن أن الياباني يستطيع الآن أن يميز القمع بوضوح على ضوء تجربته. وأنا حين أتكلم على القمع في الوطن العربي فإنني أتكلم حقيقة من المقارنة المباشرة أو غير المباشرة بين المجتمعين العربي والياباني. الوطن العربي ما زال بكامله يدفع ضرائب القمع مع استثناءات ليست كبيرة. لا أريد هنا أن أدخل في لعبة الأرقام ولن أجري دراسات مقارنة تحليلية للدساتير والقوانين العربية، فلقد قام آخرون بذلك.
إنني ببساطة سأقدم حوادث واقعية صغيرة ولكنها كافية، بالنسبة لمن يرى من الخارج، لأن تكشف عن آليات القمع اليومية في المجتمع العربي كما تبين في الوقت نفسه تلازم القمع وعدم الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن وبالتالي تجاه الآخرين من العرب والأجانب.
الخوف
مرة كنت أستمع من الراديو إلى حوار مع طالب مصري تخرج في قسم اللغة اليابانية في جامعة القاهرة. ذلك الشاب جاء إلى اليابان وهو يتحدث عن تجربته ومشاهداته. تحدث عن المواصلات في طوكيو وعن تنظيمها ودقة مواعيدها وقارن بينها وبين المواصلات في مصر. عندئذ قال معلقاً لا بد أن نتعلم من تجربة اليابان، فلا بد أن نغير كل نظامنا. فجأة قاطعه المذيع قائلاً: الكلام عن تغيير النظام غير مسموح به.
عندئذ التفت بدوري إلى كلمة (نظام) وتذكرت كم هي حساسة وخطرة في مصر. وفي البلدان العربية الأخرى. وتذكرت كيف يخاف العرب من استعمال بعض الكلمات.
بالطبع يوجد خوف في اليابان، نحن نخاف من الزلزال ونخاف من حوادث محطات توليد الطاقة بالطاقة النووية ونخاف أيضاً من أسلحة كوريا الشمالية ولكن ما أريد الحديث عنه هو كيف نواجه الخوف؟ عندنا في اليابان نحاول أن نوضح أسباب الخوف وما وراء الخوف والظروف التي تحدث الخوف لكي نتغلب عليه سوياً.
المهم لا يوجد عندنا الشخص الذي يهدد الناس ويخيفهم ليحقق منفعة شخصية. ولكن في البلدان العربية يوجد الخوف الذي يستفيد منه بعضهم ويوجد أشخاص كثيرون يستغلون خوف الناس وهذا كله مرتبط بغياب العدالة الاجتماعية في البلدان العربية. ما أريد أن أؤكد عليه هو أن مواجهة الخوف مختلفة اختلافاً كبيراً بين اليابان والبلدان العربية.
الخوف أيضاً
من يعرفون البلدان العربية قرؤوا عن السجون وهم غالباً يعرفون أسماءها من الكتب ومن الصحافة العالمية وبعض جماعات المعارضة الصغيرة. والذي يحدث عندما تسأل عن موقع سجن ما بالتحديد فإن من نسألهم يصابون بالذعر وطبعاً لا يجيبون ويهربون كأنهم واجهوا غولاً مخيفاً. منذ ثلاثين سنة لم أعرف موقع سجن عربي تماماً.
هذا أمر ممنوع ومحرم. كيف؟ هذا يحصل فعلاً. أما الأدهى من ذلك فهو خوف الناس من رجال الأمن سواء كان رجال الأمن شرطة أو شرطة سرية أو مخابرات كما يسمونهم في البلدان العربية. وليس الخوف فقط وإنما الامتياز الاجتماعي والاقتصادي الذي يتمتع به رجل الأمن. في الريف عرفنا أن الفلاحين لا يحبون الشرطة وهذا أمر مفهوم لأن هناك مخالفات لا نهاية لها ولكن ما هو غير مفهوم هو الاحترام الكاذب الذي يظهره أولئك الفلاحون لرجال الشرطة والكرم الباذخ في المآدب التي يقيمونها لهم! تلك الازدواجية سببها الأول والأخير هو القمع والخوف الثابت من بطش السلطة والمسؤولين وما أكثر النكات والطرائف التي يتداولها الناس عن اختفاء فلان أو تبخر علان لأنه تفوه بكلمة ضد مسؤول!.
في الطريق إلى بيت صديقي
أذكر حادثة بسيطة للغاية موجودة على نطاق واسع. في عاصمة عربية ذهبت لأزور صديقاً عربياً. وعندما وصلت إلى الحي الذي يسكنه فاجأتني القاذورات وفضلات الطعام وكافة أشكال النفايات وأكياس الزبالة. كانت منشورة بعشوائية على الأرض، والشارع والزوايا. على أي حال، وصلت إلى البناية التي يسكن فيها ذلك الصديق.
المدخل كان قذراً والدرج أيضاً ولكن لدهشتي فقد وجدت عالماً آخر خلف باب صديقي. كان البيت نظيفاً للغاية وكان مرتباً وأنيقاً ومريحاً. لقد فهمت أن كل ما يخص الملكية العامة يعامله الناس كأنه عدو فينتقمون منه ولذلك نجد المقاعد في الحدائق العامة مكسرة أو مخلوعة ونجد معظم مصابيح الشوارع محطمة.
كما أن دورات المياه العامة قذرة بصورة لا توصف. وحتى المباني الحكومية فقد لحق بها كل أنواع التخريب الممكنة. لقد فكرت طويلاً في ظاهرة تخريب الممتلكات العامة وفهمت أن المواطن العربي يقرن بين الأملاك العامة والسلطة وهو نفسياً في لا وعيه على الأقل ينتقم سلبياً من السلطة القمعية فيدمر بانتقامه وطنه ومجتمعه بدلاً من أن يدمر السلطة نفسها. تلك المظاهر السلبية التي ذكرتها اختفت تماماً من المجتمع الياباني.
ولكنها لم تختف منذ زمن طويل. لقد استمرت إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية بسنوات. ولكننا انتصرنا عليها وتحررنا منها وعرفنا مسؤوليتنا عن الملكية العامة معرفة جيدة.. لا أستطيع الفصل بين القمع وعدم الشعور بالمسؤولية في المجتمع العربي، كيف يتبدى الأمر للآخر غير العربي؟ بالأخص نحن القادمين من اليابان؟
عن كيفية الحكم
عندنا في اليابان النظام إمبراطوري، لكن الإمبراطور نفسه ليس له أي صلاحيات سياسية على الإطلاق ورئيس الوزراء يتغير حوالي كل سنتين لكي نمنع ظهور أي شكل من أشكال استبداد حاكم فرد.. فالحكم الطويل يعلم الحاكم القمع إذا كان لا يعرفه.
ولكن الحاكم في البلدان العربية يبقى حاكماً مدى الحياة سواء أكان ملكاً أو سلطاناً أو أميراً أو رئيس دولة أو رئيس جمهورية إلا إذا أغتيل أو حصل انقلاب مسلح ضده. على أي حال نحن لا نفهم هذا في اليابان. نحن نظن أن الحاكم يجب أن يشعر بالمسؤولية تجاه شعبه وعليه أن يعطي مجالاً لغيره لكي يخدم هذا الشعب.
أما في الوطن العربي فالسلطة والشخص شيء واحد لا يمكن الفصل بينهما. فالحاكم العربي مازال يتمتع بالامتيازات التي كان يتمتع بها الحاكم في العصور ما قبل الحديثة. بالطبع هناك استثناءات ولكنها الاستثناءات التي تثبت القاعدة كما يقال: والمعيار الوحيد لكرامة المواطن ووطنيته هو مقدار ولائه للحاكم وطاعته له والتسبيح بحمده في جميع الأوقات والظروف والمناسبات وهذا كله غريب علينا نحن اليابانيين في الوقت الحاضر على الأقل.
بعد الحرب العالمية الثانية تناوب على منصب رئيس مجلس الوزراء أكثر من عشرين شخصية سياسية ليس لأنهم كانوا غير جديرين أو غير مخلصين ولكن لأن قيادة الدولة المعاصرة أكبر من إمكانيات أي فرد لوحده مهما كان موهوباً وقوياً كما أن هذا المنصب عندنا يمارسه المسؤول مرة واحدة فقط وهكذا تضمن عدم ظهور مركزية فردية مهيمنة.
أذكر على سبيل المثال الدعابة الواقعية أن اليابانيين الذين يقيمون أكثر من شهرين في الخارج يسألون سائق التاكسي الذي يوصلهم إلى بيوتهم من المحطة يسألون عن اسم رئيسنا الحالي. وأحياناً يسمعون اسماً جديداً. ولو افترضنا أن الزعيم السياسي استثنائي فإننا نعرف أن مهام قيادة الدولة أوسع من أي فرد استثنائي.
المساواة أمام القانون
أذكر مثالاً من تاريخنا القريب: السيد (تاناكا) كان واحد من أقوى الشخصيات التي شغلت منصب رئيس مجلس الوزراء عندنا. واليابانيون أيدوه خاصة في منطقته لأنه أوصل لها خط القطار السريع، وابنته الآن عضوة بارزة في البرلمان الياباني.
ولكن الشرطة اعتقلته من بيته. وذهب إلى السجن بالقبقاب الياباني! عندما اكتشفت الصحافة والبوليس فضيحة لوكهيد لم يستطع السيد تاناكا الهروب من المسؤولية فسجن وحوكم كأي مواطن عادي.
عندنا تلعب الصحافة والشرطة دوراً فعالاً في متابعة كافة أشكال مخالفة القانون، ومن الصعب أن ينجو أحد إذا ارتكب جريمة.. الفرد هنا لا يحميه شيء إذا كان مذنباً. أما في البلدان العربية فإن القانون يجري تطبيقه على الشعب رغم أن ذلك القانون نفسه من وضع السلطة. فرجال السلطة وأقرباؤهم والتابعون لهم من الحاشية فوق القانون ولذلك يخرب كل شيء وتضيع العدالة ويسيطر القمع.
الظاهرة الغريبة
إن الحاكم العربي يخاطب الشعب بكلمة؛ يا أبنائي وبناتي، عندنا نعتبر هذه الكلمة إهانة بالغة إذا استعملها مسؤول مهما كان كبيراً.
نحن لا نقبل بهذه الصيغة نحن نقول لرئيس الوزراء أنت حر في بيتك ولكن خارج البيت نحن لا نسمح لك. نحن نعرف أن مكانة الأب شبه مقدسة في البلدان العربية داخل الأسرة استناداً إلى الدين والأعراف والأوضاع الاجتماعية التقليدية ولذلك فالأب خارج البيت رجل آخر! أنني أقدر أن الحاكم يفعل الشيء نفسه مع الشعب يضع نفسه فوق الشعب في مكانة مقدسة، أنه فوق النظام وفوق المجتمع ولذلك يستفيدون عاطفياً من لهجة الأبوة ليسيطروا على الشعب، الحكام أيضاً يرتكبون أخطاء وعلينا أن ننتبه دائماً إلى أعمالهم.
وأن نراقبهم بشدة كيلا ينحرفوا. ولذلك نحن نحتاج دائماً إلى جهاز رقابة فعال وفي البلدان العربية لا توجد الرقابة التي تحقق العدالة الاجتماعية لأنهم لا يوضحون ولا يكشفون عن الأشياء المخبوءة.
حاكم كفرد
الفكرة الأساسية تكون على النحو التالي عندنا؛ كل شخص عنده مهمة صغيرة أو كبيرة، الحاكم عنده مهمة أكبر وعنده قدرة محدودة. والناس يثقون بهذه القدرة ولكن من الطبيعي أن تظهر الحقيقة وأن تظهر نقاط الضعف.
كل إنسان عنده نقاط ضعف نحن لا نلوم من يفشل عندما يبذل كل جهوده على العكس نقدر تلك الجهود ولكننا نغير الفرد الذي يفشل ونحاسبه إذا كان تقصيره سبباً للفشل وبعد المحاسبة يستطيع أن يستمر في حياته كأي فرد آخر.
جهة من العنصرية
أفهم العنصرية على أنها سلوك متعال ومتغطرس، العنصرية موجودة بقوة عبر التاريخ ولا حاجة هنا لتكرار ما يعرفه الجميع من إدعاء بعض الشعوب التفوق على أساس العرق، واختلاف اللون. لقد عانى بنو البشر طويلاً من العنصرية.
ونحن اليابانيين عشنا تجربة مريرة. لقد مارس العسكريون اليابانيون عنصرية ضد الشعوب المجاورة. وضد الشعب الياباني نفسه. وأنا لا أنفي وجود أشكال من العنصرية عند اليابانيين حتى الآن. من جهتي أعتبر كل سلوك يميز صاحبه نفسه عن الآخرين من فوق هو سلوك عنصري. تأخذ العنصرية أشكالاً مختلفة، أمة ضد أخرى أو طبقة ضد أخرى أو فئة اجتماعية ضد غيرها من الفئات أو فرد يضع نفسه فوق الآخرين.
وأنا أقدر أن العنصرية مازالت موجودة في بني البشر في كل مكان، ولكي نتخلص من العنصرية نحتاج إلى ثقافة عالية، ووقت طويل لا يعرف مقداره. نحن البشر لا نستطيع الآن أن نتخلص من العنصرية على ما يبدو، ولكننا نستطيع أن نخفضها إلى الحدود الدنيا.
العرب كما هو معروف مورست عليهم العنصرية وما زالت حتى وقتنا هذا. والأمثلة أكثر من أن تعد. ومع هذا فقد شعرت عميقاً أن العرب يمارسون العنصرية داخل مجتمعاتهم ضد بعضهم بعضاً على أكثر من شكل.
وسأكتفي بمثال واحد على ذلك ومثالي هو أصحاب السيارات الخاصة. يتفاخر مالك السيارة بسيارته وكأنها مجد فريد أحرزه دون غيره من بني البشر. ولذلك يتبارى الأغنياء بشراء أحدث موديلات السيارات وأعلاها ثمناً. وهذا التفاخر الصريح يتحول إلى تعالي على الآخرين، واضطهاد لهم مع أن ملكية السيارة في البلدان المتقدمة صناعياً ليس امتيازاً، ولا يختلف كثيراً عن ملكية دراجة عادية.
في عام 1989 كنت في القاهرة للمشاركة في ذكرى مرور مائة سنة على ولادة الكاتب الكبير طه حسين. ومرة كانت توصلني إلى الفندق صاحبة شقتي. وفي الطريق صدمت عربة يقودها فتى لم يتجاوز العاشرة من عمره. سقط الفتى على الأرض وتناثرت البضائع الصغيرة التي كان يبيعها. في حالة كهذه فإن أقل ما يمكن أن يفعله السائق هو أن يطمئن على ضحيته وأن ينقلها إلى أقرب مستشفى ولكن الذي حصل أن تلك السيدة رشقت الفتى بنظرات احتقار ووصفته بالحيوان المتخلف الغبي وتابعت سيرها وكأن شيئاً لم يحدث.
بالنسبة لي كنت مصدوماً من سلوكها للغاية ولم أكد أن أصدق ما حصل. أنا لم أتوقع منها هذا السلوك اللاإنساني الفظ تجاه شاب فقير يسعى لكسب رزقه في ظروف صعبة وعلى عربة خشبية بسيطة. إنني أرى سلوكها سلوكاً عنصرياً تجاه من هم أقل مرتبة في سلم الغنى لأنها تملك سيارة!
وأقدر أن المواطن العربي ليس بحاجة إلى أمثلة أكثر لأنه يعاني يومياً من إزعاج أصحاب السيارات الخاصة بأشكال مختلفة، ومن جهتي فإنني أفهم سلوك الطبيبة وما شابهه على أنه شكل من أشكال استيقاظ العنصرية في داخل الفرد الذي لا يهتم بكرامة الآخرين.
الأطفال والتعليم
في البادية السورية عرفت ابن صديقي أبي عبد الله وأسمه جاسم. كان في السادسة من عمره عندما قابلته أول مرة طفل هادئ وصامت. يشع من عينيه ذكاء خاص وشرود يشبه شرود المتأمل. كان دائماً يراقبني بهدوء ويتحدث معي بالطريقة نفسها. كل شيء في ذلك الطفل كان يوحي بأنه سيصبح كاتباً أو شاعراً لو كان طفلاً في اليابان.
بعد عشر سنوات رمى جاسم موهبته كلها وأصبح راعياً نموذجياً كما يتوقع منه المجتمع. لقد قابلت فتيات وفتياناً صغاراً موهوبين ولكنهم انتهوا إلى أفراد عاديين لأنهم لم يجدوا أي نوع من الرعاية لأن المجتمع يحتاج إلى قدرة واحدة تناسبه كراع.
المجتمع العربي عامة ليس عنده استعداد ليربي المواهب ويقويها. الأمر مختلف عندنا في اليابان لأننا نعتبر الموهبة الفردية قدرة تحقق نجاحاً في حياتنا. ولذلك يراقب الوالدان الطفل ويدققان في قدراته في الموسيقى والعلم والرياضة. هذه ظاهرة اجتماعية عامة في اليابان. كل والدين يراقبان يبحثان بعدئذ يقدمان كل إمكانياتهما لدعم موهبة الطفل.
في مجتمع البدو مستقبل الأطفال واضح؛ الولد يصبح راعياً والبنت عروساً. أما في مجتمع الفلاحين فالأمر متروك للمصادفة. ربما كان الوضع أفضل قليلاً في المدن العربية. ولكن الصورة العامة دون المستوى المطلوب من الشعور بالمسؤولية عن مستقبل الطفل. أتساءل دائماً؛ هل الوضع الاقتصادي هو المسؤول؟ في المدرسة الابتدائية اليابانية يوجد نواد لكل أنواع النشاطات؛ الموسيقى الرسم النجارة الخياطة السباحة وكل أنواع الرياضات الخ.
وفي كل مدرسة مسبح نظامي وحديقة زراعية صغيرة وفي كل مدرسة مكتبة وقاعات للأطفال باختصار المدرسة مجهزة عملياً لكي يمارس التلميذ أي هواية يرغب فيها وهو يستطيع أن يجمع بين عضوية عدة نواد كما يحب. فلماذا لا نجد شيئاً من هذا تقريباً في المدارس العربية؟
أن الأمر يعتمد على المعلم والتلميذ بالدرجة الأولى وليس على الغنى أو الفقر. أقدر أن السبب هو غياب الشعور بالمسؤولية العامة. غياب الشعور النابع من وجدان الفرد بأنه مسؤول عن مستقبل كل الوطن. ولذلك نسمع أخباراً محزنة عن أشكال الغش والتلاعب في التدريس والامتحان واختيار الأساتذة وكل ما يتعلق بالعملية التربوية.
وما دمنا في مجال التعليم فإن علينا أن نقر بأن وضع المعلمين في الدول العربية غير النفطية لا يحسدون عليه. فالمرتبات متواضعة للغاية والعلاوات غائبة والتشجيع غير موجود بالإضافة إلى غياب التقدير الاجتماعي لمكانة المعلم وهذا كله على عكس مما هو عندنا في اليابان. فمثلاً لا يحق لأحد أن يفصل معلماً أو مدرساً أو أستاذاً جامعياً من عمله.
حتى البرلمان ليس له هذه الصلاحية والمعلم محمي بقوة القانون وقوة تقدير المجتمع ما لم يرتكب جريمة بالمعنى القانوني. نحن نتشدد في اليابان في التعليم إلى درجة إرهاق التلميذ أحياناً خاصة في المراحل ما قبل الجامعية.
الأطفال والقمع
في العديد من المدن العربية يكثر وجود الباعة الصغار ومعظمهم في سن التعليم الابتدائي كما يكثر عدد ماسحي الأحذية من أولئك الصغار أيضاً. وفي الأحياء الشعبية في بعض المدن يتجمع الأولاد على السائحين خاصة يطلبون نقوداً! بالنسبة لي اكتشفت حلاً للخروج من إحراج ذلك المشهد الحزين بفضل استغلال نقاط خوفهم.
تحت هذه الحالة كنت أسأل الولد عن اسم أبيه أولاً وعن اسم معلمه في المدرسة ثانياً. وعلى الفور كان يختفي من أمامي. هذا يعني أمرين. أولهما أن الولد يتسول دون معرفة أهله وثانيهما أن الأب والمعلم يمثلان سلطة مخيفة بالنسبة للطفل. إن مشكلة عمل الأطفال وتسول الأطفال وتشرد الأطفال مشكلة عالمية في البلدان الفقيرة ولكننا لا نجد في اليابان ظواهر من هذا النوع.
إن قمع الطفولة مسؤولية عامة في المجتمع العربي وهذا القمع يتخذ أشكالاً مختلفة فعلى سبيل المثال لم أجد في مدينة عربية مرافق عامة خاصة بالأطفال.
بالطبع هناك بعض الحدائق المتخصصة للأطفال. ولكن عندنا في اليابان مثلاً تحسب حساب الطفل كجزء أساسي من بناء أي حي أو مرفق عام. الأطفال في المدن العربية يلعبون على الأرصفة وفي الأزقة والشوارع أحياناً وهم بذلك يعرضون أنفسهم للخطر ويسببون إزعاجاً للآخرين أيضاً.
إن رعاية الطفولة ضعيفة للغاية في البلدان العربية بدءاً من الأبوين وانتهاء بمؤسسات المجتمع. لقد عرفت في كل مكان زرته من الوطن العربي أن الوالدين يضربان الطفل بصورة شبه يومية وكأن الأمر طبيعي. هذه الظاهرة اختفت بصورة شبه كاملة من المجتمعات المتقدمة. فهل يبدأ المجتمع العربي مسيره نحو الحرية وإنهاء القمع من تحرير الطفولة ورعايتها والحرص على نموها بشكل طبيعي حر؟
فكرة الخلود والحاكم
منذ فجر التاريخ كان سكان حوض شرق البحر الأبيض المتوسط مشغولين بفكرة الخلود. المصريون القدامى والبابليون والآشوريون والعرب في شبه الجزيرة العربية يتجلى ذلك الانشغال القوي في الآثار المادية التي تركها أولئك الأوائل، ويتجلى في الكتب الدينية بصورة خاصة. لقد ظهرت فكرة التوحيد في وادي النيل كما تجمع الدراسات جميعاً.
وفي ذلك المناخ المنهمك في البحث عن الخلود ظهرت المعابد المصرية الكبرى والتحنيط والإهرامات وغيرها من الأعمال التي تحاور المطلق المتعالي عن الزمان والمكان. والآثار الآشورية العملاقة بالإضافة إلى آثار من الشواطئ السورية تشير إلى العشق الكبير للخلود. الله في ثقافات هذه الشعوب واحد لا شريك له.
في وادي النيل وفي بلاد ما بين النهرين. ونحن هنا نتكلم عن التاريخ الأقرب الذي قضى على فكرة تعدد الآلهة بصورة نهائية تقريباً. إن فكرتي التوحيد ومشكلة الخلود تشكلان إحدى المزايا الأساسية المميزة لتاريخ المنطقة الثقافي قبل الديانات السماوية ومعها. وهذه المسألة في أحد وجوهها على الأقل تعبر عن الحركة الاجتماعية لتلك الشعوب كما تدل بوضوح على مفهوم الحاكم الفرد المطلق.
في اليابان فكرة (الله واحد) بعيدة عن إدراكنا. في ديانة شينتو وفي الديانة البوذية لا مكان لمفهوم الله الواحد. عندنا في ديانتنا وفي ثقافتنا العامة إلهة كثيرة. ورغم أن البلدان التي تعتنق الديانة البوذية عرفت سلطة الفرد الواحد المطلقة إلا أن تعدد الآلهة بقي مستمراً في عقائد هذه الشعوب. وبناء على ذلك فإن إنشغالنا بالخلود مختلف عن انشغال العرب، باعتبار أن العرب ورثوا ثقافات منطقتهم وتوجوها بما أبدعوه بأنفسهم وبالدين الإسلامي كدين نهائي وأبدي للبشرية حسب اعتقاد المسلمين.
نحن في اليابان على العكس من ذلك نؤمن بوحدة الوجود. ولذلك ليس عندنا مركز للعالم. في الثقافة العربية الإسلامية الإنسان هو مركز العالم فلا عجب أن يكون الحاكم مركز الشعب. أي الحاكم مشروع للبقاء الدائم المتعالي. والحاكم المستبد سرعان ما يصبح مفارقاً للشعب ولذلك قال بعض الحكام العرب قديماً بالوهتهم أو قال عنهم الناس.
أعترف أن المسألة معقدة وأنا لا أدعي الإحاطة بها كما ينبغي ولكننا نعرف ببساطة أن العرب المعاصرين يضيفون صفة الخلود حتى لرؤسائهم مثل الزعيم الخال زعيمنا الى الابد.. وهكذا ان هذا الابد المضفى على الحاكم مثير لنا في اليابان ويفوق قدرتنا على التصور وأحياناً يفوق قدرتنا على الفهم.
فكرة (التأبيد) لا تقتصر على رجل السلطة الكبير وإنما تشمل قادة الأحزاب التي يفترض انها في المعارضة والأحزاب المعارضة من المفترض أن تحمل مشروعاً مناقضاً لمشروع السلطة القائمة ومختلفاً عنه وإلا فإن المعارضة تصبح سلطة تنتظر دورها في السيطرة على الحكم استلاماً يؤبد المشروع السائد.
فعلى سبيل المثال يتمتع انطون سعادة لدى أتباعه في الحزب السوري القومي الاجتماعي بكل خصائص المقدس الكامل وبالتالي الخالد! ولا يجوز لأعضاء الحزب أن يغيروا أو يبدلوا في مبادئه. وأسارع فأقول أنني أقدر الجميع وأحترم الجميع ولا أبغي هنا الإساءة لأحد بالمعنى الشخصي ولكني أحاول أن أرى من الخارج الفروق بين السلطة القمعية والمعارضة التي هي بدورها سلطة قمعية فيما أرى ويتجلى قمعها في نفي أفكار الآخرين. وفي مصادرة حق الآخرين في التجديد.
إن كل حزب يدعي بأنه يمثل وحده الحقيقة ويمثل مصالح الشعب هو بشكل ما حزب ديكتاتوري سواء أكان في السلطة أو خارجها. وكمثال آخر حزب البعث العربي الاشتراكي أكبر حركة قومية عربية منظمة ولقد استلم السلطة في بلدين عربيين كما هو معروف وهو بدوره ينص دستوره على أن الحزب لا يحق له تغيير أو تعديل أو حذف المبادئ الأساسية التي أقرها مؤتمره الأول عام 1947م. والقارئ العربي يعرف أن السيد خالد بكداش بقي رئيساً مطلقاً للحزب الشيوعي السوري منذ شبابه حتى وفاته. وبعد رحيله احتلت زوجته منصب زعامة الحزب كما أن ابنه عضو في مكتبه السياسي ولنا أن نفترض أنه سيرث السيدة الوالدة بعد عمر طويل إن شاء الله.
أنني أريد أن أقول بكلمات مباشرة واضحة؛ أن المعارضة القائمة في البلدان العربية هي في حقيقتها سلطة ضد السلطة أو سلطة مضادة تطمح للسيطرة على الحكم دون أن تقدم مشروعاً مغايراً لمشروع الحكم المسيطر. ولذلك فالمعارضة في البلدان العربية آمنة. لها مكاسبها ولها مشاركتها المباشرة في الحكم أحياناً. أما المعارضة الحقيقية التي لا نستطيع أن نقابل أفرادها فإنها في السجون العربية أو في المنافي الاضطرارية. فالسلطات العربية تميز بحزم بين المعارضة الآمنة والمعارضة التي تهدد وجودها ولذلك فإن الحكومات العربية جميعاً لا تتردد في قمع المعارضة الفعالة ولا تتردد في القتل عندما ترى ذلك ضرورياً.
يعرف الجميع أن بعض الأنظمة العربية تحظر الأحزاب بكل أنواعها والشعار المشهور (من تحزب خان) يطبق عملياً بحزم ليس في ليبيا وحدها بل في السعودية والسودان وغيرها.
- يوم مات الزعيم – صورة الزعيم
كنت في القاهرة يوم مات الرئيس جمال عبد الناصر..لقد رأيت الحزن الكبير الصاعق الذي سيطر على الناس ولكنني رأيت أيضاً. الحيرة والفوضى تسيطر على الناس، كان الناس كأنهم سكارى وما هم بسكارى وكأنهم فقدوا العماد مثل المركب الذي تحطم والركاب لا يعرفون إلى أين يمضي بهم ما بقي بين أيديهم. لقد فهمت الوزن الكبير الذي يُعطى للزعيم في مصر. الناس يحتاجون إلى زعيم أو على الأقل يبدو على المصريين أنهم يحتاجون إلى زعيم.
وقد فهمت فيما بعد أن موت جمال عبد الناصر أحدث شيئاً مشابهاً لما حدث في مصر في البلدان العربية الأخرى. خرج الناس إلى الشوارع يلبسون السواد ويبكون يندبون ويهتفون للرئيس الراحل. بالطبع كان جمال عبد الناصر ذا شعبية كبيرة في الوطن العربي ولذلك أحدث رحيله فراغاً كبيراً لدى محبيه وأتباعه ولكن ذلك كله طرح السؤال التالي:
من هو الزعيم الحقيقي؟ كيف يجب أن يكون الزعيم؟ من هو الزعيم الجدير بالثقة؟ لماذا يحتاجون زعيماً إلى هذه الدرجة؟ بالمقارنة، ربما نقدر أن نقول إننا – نحن اليابانيين – نحاول أن نعتمد على شيء آخر. عندنا في اليابان صورة الزعيم فقيرة جداً. لقد فقدنا الصورة الحقيقية للزعيم. إننا نرى كيف يتبارى قادة الأحزاب والشخصيات المهمة لكسب أكثرية الأصوات. الزعيم الحقيقي – في تصوري – لا يلهث وراء السلطة، السلطة نفسها تأتي إليه يفرضها عليه وعي المسؤولية والشعور العميق بالواجب. ولكي أتجنب تقديم صورة لزعيم جديد بقيادة شعبه من تاريخ اليابان وتاريخ البلدان العربية فإنني أسمح لنفسي بأن اشير إلى صورة الزعيم كما يقدمها الأدب الرفيع واختار صورة الزعيم من رباعية الروائي العربي الليبي إبراهيم الكوني (الكسوف) وأقدم للقارئ صورة (غوما) كزعيم توضحت فيه صفات رجل القيادة في ظروف خاصة قاسية.
عن الثقة
تاريخ الثقة طويل في اليابان. ولكننا بعد الحرب فقدناها بصورة مؤقتة وبسبب الفوضى الاجتماعية والفقر وغياب الحاجات الأساسية تصرف الناس بدون وعي الثقة.
بعد ذلك رجعنا إلى الحالة السابقة واعتبرنا الثقة رباطاً يشد المجتمع كله. حتى التجار يرون أن الثقة مهمة ويقولون أنهم إذا فقدوا الثقة فقدوا تجارتهم كلها. هذا يعني أن التجار يثق بعضهم ببعض وبالطبع يثقون بالربح.
أذكر مثالاً بسيطاً من تجربتي الشخصية: في امتحانات آخر السنة في جامعتنا أنا أوزع الأوراق وأسئلة الامتحان على الطلاب. وأتركهم بلا مراقب وأعود إلى مكتبي. وفي نهاية حصة الامتحان أعود لأجمع إجابات الطلاب.
أنا أريد أن أجعل الطلاب يتصرفون بثقة، وإذا صادف أن غش أحدهم فإن زملاءه يعتبرونه خائناً للثقة. الرأي السائد ضمنياً عندنا في اليابان بالنسبة للفرد هو: أنا مضمون بهذه الثقة. الثقة ضمانة وكمثال أقدر أن الصحافة في اليابان تشتغل على أساس الثقة. وأهم مسألة في الصحافة عندنا أنها تقدم حقائق. وإذا حدث احتمال للكذب أو الكلام بلا ثقة فإن الصحافة عندنا أنها تقدم حقائق. وإذا حدث احتمال للكذب أو الكلام بلا ثقة فإن الصحافة الصحافة تتعرض لحالة خطيرة. ولا بد من توضيح ذلك. نحن اليابانيون نراقب ذلك بصمت ولكن بشدة.
في البلدان العربية هناك ظواهر كثيرة تدل على غياب الثقة عن العلاقات الاجتماعية. وعلى سبيل المثال فقد شاهدت كثيراً من الآباء يستخدمون القوة مع أبنائهم لكي ينفذوا شيئاً نموذجياً مرغوباً. مرة أهديت ابا عبد الله منظاراً عادياً، حرك الفضول أولاده لاستخدام الجهاز، وقرأت في عيونهم حب الاستطلاع ولكن صديقي قال لأبنائه: لا تمسوا المنظار، إذا واحد منكم مد يده عليه فسأقطعها. بعد ذلك التهديد لم يقترب أحد منهم من الجهاز. أمر واحد نفذ الأب ما يريد بشكل كامل.
كان عندنا أيضاً في عصر ميجي (عصر النهضة) الأب المخيف المهاب، وبالتدريج تحولت تلك الصورة وأصبحت العلاقة بين الأباء والأبناء تقوم على الثقة. إن غياب الثقة في الأسرة يؤدي إلى حدوث جرائم كبيرة. ولقد شاهدنا الكثير من تلك الجرائم.
ليس السلوك على أساس من الثقة سهلاً ولكن علينا أن ندرك ذلك ولا بد – هنا في اليابان – أن نعتمد على الثقة بين الوالدين وأولادهما.
ثقة في المجتمع
وكمثال آخر. الناشرون عندنا ليسوا تجاراً. أنهم يشتغلون في ميدان الثقافة. هكذا يعتبرون أنفسهم. لقد سمعت من كتاب عرب أن الناشرين يستغلون الكتّاب. ويسرقون حقوقهم! اننا من الصعب أن ندرك ذلك، أو نفهمه، والجميع يعرفون ظاهرة تصوير الكتب، ونشرها دون إذن من المؤلف أو دار النشر صاحبة الامتياز.
هذا لا يحصل عندنا على الإطلاق. كثيراً ما تقوم العلاقات في البلدان العربية على الصلات الفردية أو الخدمة الخاصة، أو أسوأ وسيلة وهي الرشوة. تغيب الثقة فيحل محلها المنفعة المتبادلة ونحن نسمع دائماً تعبير من نوع: عشان خاطرك! وهكذا تحدث أشياء غير قانونية. ويتبادل الذين يخالفون القوانين الحماية والمكاسب.
في أواخر شهر أيلول عام 1999حدث عندنا في اليابان تسرب إشعاع من محطة توليد الكهرباء بالطاقة النووية. حدث ذلك في معمل محافظة إيباراغي. ذلك الحادث سبب صدمة شديدة لكل اليابان. ولقد بذلت جهود كبيرة لتوضيح كل شيء للناس. ذهب خبراء وعلماء إلى مكان الحادث ووضحوا أسبابه عبر التلفزيون والصحافة تلك مرحلة أولى، أما المرحلة الثانية فكانت تحديد المسؤولية عن الحادث ولماذا حدث ثم كيف نمنع وقوع حادثة مماثلة؟ وما زلنا نتابع كل المراحل هذه لسببين:
1- توضيح المسؤولية وتحديدها.
2- لكي نمنع تكرار الخطأ.
ولكي نستعيد الثقة المشتركة بين الحكومة وسكان المنطقة، إن وعي الثقة يحدد السلوك ويوجهه، وكأن الثقة جهاز يضبط المجتمع ويحافظ عليه سليماً.
إذن في اليابان يحدث أحياناً أن تخرق الثقة وإذا حدث ذلك فإن المجتمع كله يراقب ويتابع ويحكم بنفسه. وأقدر على ضوء تجربتي المتواضعة في البلدان العربية أن مفهوم الشرف والعار يحل محل مفهوم الثقة في مجالات واسعة من الحياة الاجتماعية العربية.
أذكر مثالاً آخر من اليابان. العمال يثقون بشركاتهم التي يعملون بها ثقة كبيرة ويعملون فيها ويدافعون عنها وكأنها شركاتهم الخاصة. والعاملون (الإدارة والموظفون والعمال) يصدقون الإدارة ويطيعونها. هناك عقد قائم من الثقة المستمرة – وليس مكتوباً – هو أن الشركة ستحافظ على العاملين فيها وستشاركهم أرباحها ولن تتخلى عنهم. هذه الثقة ميزة فريدة في ميدان العمل في اليابان. ولكن مع الأسف بدأت بعض الشركات تخرب هذه العلاقة التي تميز الاقتصاد الياباني. فنحن نسمع في السنوات الأخيرة عن تسريح عمال أو تقليل عدد الوظائف للعاملين الجدد. أو إغلاق بعض فروع الشركات بسبب أزمات مالية. اليابانيون جميعاً يراقبون باهتمام شديد ما يحدث، وأقدر أننا نتمسك بقوة في تثبيت الثقة كرباط اجتماعي يضمن لنا حياتنا في الحاضر والمستقبل.
إنني أسال الأسئلة التالية البسيطة عن المجتمعات العربية:
- هل يثق الآباء بأبنائهم؟ وهل تثق الزوجة بزوجها؟ وهل يثق الفرد بأقربائه وجيرانه وأبناء مجتمعه؟
- هل يثق المواطن بأحزابه السياسية؟ ام هل يثق بحكامه؟
- هل يثق المواطن العربي بالصحافة والقضاء والقوانين العامة؟
- هل يثق العاملون بإداراتهم وأرباب عملهم؟
- هل يثق الفلاح بالتاجر الذي يشتري محصوله؟ وهل يثق المشتري بالبائع؟
- إلى آخر هذه السلسلة من الأسئلة الموجعة الجارحة. إن الثقة لا تستورد ولكنها تنبت في النفوس وتنمو برعاية المجتمع كله. فمتى تعتمد المجتمعات العربية على رباط الثقة؟. | |
|









 لا اله الا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين
لا اله الا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين 